النزعة الصوفية في شعر الشاعر السوري منذر يحيى عيسى في مجموعته الشعرية ” وحيدًا ستمضي ” دراسة نقدية ذرائعية _ بقلم : د. عبير خالد يحيي
#سفيربرس
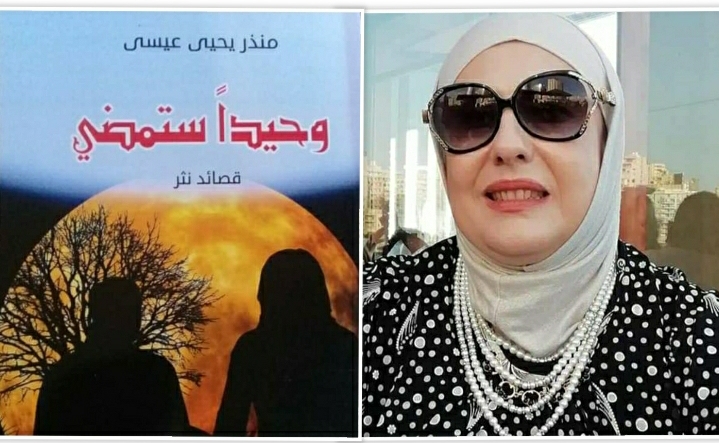
إن الشعر لم يكن في أي زمان ولا بأي لغة بعيدًا عن المفهوم الإنساني للتصوّف, من حيث أنه استنباط لتجربة روحية, ومحاولة للكشف عن الحقيقة, عبر التخطّي عن الوجود الفعلي للأشياء, والشعر في تطور دائم وحركة مستمرة, ومُحال أن يصدر الشعر عن ثبات أو جمود, فهو تغير مستمر وصراع ومعاناة, وكذلك حال التصوّف, كما يقول صاحب الطبقات الصوفية: التصوّف اضطراب فإذا وقع السكون فلا تصوّف.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أحوال الصوفية : كالمراقبة والمحبة, والخوف, والرجاء, والشوق, والأنس, والطمأنينة, والمشاهدة واليقين, وجدنا أنها تكاد تكون أحوال الشاعر في وضع الإلهام.
“والظاهرة الصوفية في النص تتحرّر من المرجعية الدينية, وتستبقي الجانب الإنساني والرغبة بالسمو البشري والسلام الداخلي, طبيعة النص الصوفي تلائم التعطّش البشري للتواجد بآليات سردها وفنّياتها البلاغية, ولا يمكن تصنيفها كأدب إسلامي بل كأدب روحي” .
تجنيس المنجز الأدبي: شذرات + قصائد نثر في الأدب الصوفي.
أول ما يلفت العين والنظر في متن هذا المنجز هو شكل النصوص, وتموضعها على الصفحة, كلها تشغل منتصف الصفحة, القصائد والشذرات, وتأخذ شكلًا أشبه ما يكون بالنقوش أو الزخرفات الفارسية على سجادة عجمية, عمود يتسع ويضيق, فقد يكون السطر جملة طويلة من عدّة كلمات, وقد يكون جملة متوسطة الطول, وقد يكون كلمة, وقد يكون سطرًا فارغًا. ومن هذا التباين في الاتساع والضيق يتشكّل سواد القصيدة في منتصف البياض, برسومات تجريدية.
وللنقاط البينيّة, التي شاهدناها بكثرة, دلالاتها, لننظر إلى أهميتها :
لا تَقْتُلُوْهــا… إنَّها الفَراشة
تلك النقاط البينية, دالّة بصرية محذوفة تفكيكيًّا, مع أنها تغوص في مدلولها الإيحائي إلى أعمق المضامين المخبوءة وغير المرئية في المعنى, وبمفاهيم مؤجلة مفادها: لا تقتلوها إنها لم ترتكب إثمًا ولا ذنبًا ولا جريمة تستوجب قتلها, كلكم تعرفونها وتعرفون رقّتها وبراءتها.
أمّا النقاط في آخر الجملة :
حِقْداً وغَيْرةً…
وتَصْعَدُ العاصِفةُ دُرُوْبَ السَّماءْ…
فهي دالّة بصرية لجملة سياقية محذوفة, تعوّض عن زيادة في تعداد, أو وصف, أو امتداد زمني لفعل في السياق, أو استمرار لحدث, لكَ أن تتخيّله.
متقمّصًا حال الشاعر الصوفي, وعلى مستوى المضامين الكلية, ينثر شاعرنا منذر يحيى عيسى شذراته وقصائده الشعرية بمواضيع فكرية وروحية تعكس تجربته الذاتية وانفعالاته الشعورية, في قالب فني غني بالجماليات البلاغية وعلم الجمال وسيميائية ورمزية الإيحاء, وهي مواضيع شديدة الذاتية, ولا تخرج عن علاقة الشاعر بذاته, وقد يتجاوز إلى العلاقة بالآخر, دون تمييز أو تخصيص, إضافة إلى علاقته بالذات الإلهية, والوجود كإطار مكاني يوجد ضمنه, في سياق هذه المواضيع نجده يركز على معاناته الروحية, دون أن يغفل عن تناول القضايا الكبرى ضمن ذات السياق, معطيًا الأولوية للأبعاد الروحية والوجدانية في التعبير عن جوهر الإنسان وحقيقة وجوده.
تتّسم اللغة الصوفية باللامحدودية وكثرة التخييل, واتساع الرؤيا, لأنها تصور تجارب ميتافيزيقية غيبية متعالية عن الحس والعقل, وتستجلي مواضيع الذات والروح والغيب والكشف.
وتأسيسًا على هذا الفهم يمكن القول: “إن لغة التصوير الصوفي لغة أدبية محضة, لا تختلف عن لغة الأدب سوى في نوعية الموضوعات التي يعالجها الصوفي, وفي درجة تفاعلها مع العالمين المادي الواقعي والميتافيزيقي اللذين تصورهما, وفي طرائق توظيفها للصيغ التصويرية, والأساليب التعبيرية المتاحة للصوفي, ومن هنا, تتسم بمفارقتها لهذه اللغة” .
تجمع الشذرة بين الفلسفة والشعر, وتتأرجح بين الذهن والوجدان, والشعور واللاشعور, والعقل واللاعقل, والصحوة والهذيان.
أما القصيدة الصوفية المعاصرة, فهي تجربة في غاية التميّز, إذ أنها تفرغ المفردات اللفظية من دلالاتها السيميائية وتأخذها باتجاه المعاني الروحية, وتحمّلها بحمولات إيحائية تقصيها تمامًاعن التأويلات الأولية بدعوة صريحة لإعادة قراءة النص مرات عديد لاستجلاء معاني تلك الحمولات, والوقوف على القيم التي تحملها تلك الألفاظ التي تميّز اللغة الصوفية, وهذا ما لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال الاعتراف بتفرّد اللغة الصوفية المعاصرة بظواهر جمالية.
وبما أن القصائد في هذه المجموعة هي قصائد نثرية, فالإيقاع فيها داخلي, قائم على :
• التكرار:
” أسلوب التكرار جاء بمعنى إعادة الكلمة أو العبارة بلفظها ومعناها, للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو التعظيم, أو التلذذ بذكر المكرّر” , ويمتد التكرار من الحرف إلى الكلمة إلى العبارة.
ولقد رصدنا في القصائد تكرارًا لكلمات بعينها في المقطع الواحد أو في القصيدة الواحدة, كما في قصيدة ( لا تقتلوها, إنها الفراشة) , حيث كرّر الشاعر لفظ ( الفراشة) و( الشعلة) و( قلبي) وعبارة (الفراشة قلبي):
الفراشةُ قَلْبي مَعَ الشُّعْلةِ
سِرٌّ عَظِيمْ…
بَعْدَ أنْ يَسْرِيَ النُّوْرُ في القَلْبِ
يُصْبِحُ عاشِقاً لذاتِهِ
قَلْبي صارَ شُعْلَةْ…
استخدم الشاعر أربع ظواهر جمالية:
1- الانزياح بنوعيه: الدلالي ( استعارة – كناية – مجاز مرسل),
والتركيبي ( التقديم والتأخير – الحذف): لقد استخدم الشاعر هذا الانزياح التركيبي في قصيدته
( لا تقتلوها, إنها الفراشة), حيث قدّم جملة القول, وأخّر فعل القول:
هلْ مَوْتٌ
بَعْدَ مَوْتِنا الأَكِيدْ؟
أَمْ شَكْلٌ آخَرَ للحَياةْ؟!
تَسْأَلُ الفَراشَةُ:…
وهدف الشاعر من ذلك إلى لفت انتباه المتلقي للعنصر المقدّم, لجملة القول, لينتبه إلى جملة التساؤلات الوجودية التي يطرحها على لسان الفراشة الرمز.
– الحذف :
يلجأ الشاعر إلى سمة الحذف, ويترك إشارة للدلالة على حذفه بتوظيف النقاط ليترك المجال للقارئ ليملأ الفراغ الذي تعمّد الشاعر تركه عن طريق القرينة التي تركها ليجعل الشعر يتصف بالنقص, وعلى المتلقي إكمال المعنى بتأويلاته المتعددة ليشترك معه في إيصال المعنى.
من قصيدة ( تقول التجربة), حذف الشاعر عبارة بعد (ولم أزل), وترك للمتلقي نقاط, وحرية الاستئناف, والاشتراك بوضع المعنى بتأويلاته:
نَثَرْتُ بُذُوْرَ لَهْفتي
خَوْفَ الغَيْرةِ
وسَطْوةَ اللُّصُوْصِ
وانْتَظَرْتُ ولمْ أَزَلْ…
2- المفارقة :
استخدم المفارقة التضادية Paradox,
في غيابِكِ… أكونُ أنتِ
وفي حُضورِكِ الطّاغي قدْ لا أكونْ…
أتى الشاعر بظاهرتين متضادتين لا يمكن أن تجتمعا, وهما ( الحضور والغياب), كما أتى بالكينونة وضدها, وكأنه يلفت انتباه المتلقي ليقوم بعصف ذهني وليتأمّل في هذه المرتبة الصوفية التي يكونها في الغياب, ويتمنى أن يكونها في الحضور.
والسخرية Irony: حيث عمل الشاعر على خلق توتر دلالي في القصيدة, باستخدام أسلوب الذم بصيغة المدح, بهدف رسم ابتسامة سخرية من المذموم على وجه المتلقي, وقد استخدم الشاعر هذا الأسلوب على سبيل المثال في قصيدة ( مرفأ القلب):
تُناوِرينَ للدُّخُوْلِ إلى مَرْفَأِ قَلْبي
بحَذاقةِ رُبّانٍ ماهِرٍ
أَدْمَنَ حَنَقَ الأَمْواجِ وقَساوةَ الأَنْواءِ
فمِنْ أينَ يَأْتِي كُلَّ هذا الدُّوارْ؟!.
3- الرمز الصوفي:
اللغة الصوفية تجنح للرمز والإيحاء لتصنع عالمها الخاص الذي يميزها عن اللغة المعتادة في الحياة اليومية, والرمز هو الخلاص, لأن اللغة العادية عاجزة عن احتضان التجربة الصوفية. ومن الرموز الصوفية : رمز للمرأة والخمرة والطبيعة.
رمز المرأة: لقد نصّب الشاعر منذر يحيى عيسى المرأة رمزًا صوفيًّا ووضع لها قرائن عديدة, أدخلها في المقامات العرفانية, في فلسفة الحضور والغياب, فهي ذاته حين تغيب ( مقام الغياب), وهي حضور يسعى لبلوغه (مقام الحضور), كسعي المريد إلى بلوغ بهجة الحضور مع الذات الإلهية, وهي الضياء والنور حين التجليّ ( مقام الكشف والتجلي).
من شذرة ( صدمة الضياء) نلتمس الشاهد:
في غيابِكِ… أكونُ أنتِ
وفي حُضورِكِ الطّاغي قدْ لا أكونْ…
رمز الخمرة: السكر الصوفي هو سكر نفسي روحي, تغيب فيها الذات عن العالم الحسي دون الغشية, إن ما يبرّر استعمال الشاعر الصوفي للخمرة المسكرة التي حرّمها الله كرمز معنوي, هو معادلة موضوع الغياب عن العالم الحسي المليء بالألم والشقاء ليقع في عالم الأحلام والرؤى الحافل بالنشوة والسعادة, يستخدم الشاعر الصوفي العديد من المفردات والرموز المرتبطة بالخمر, للتعبير عن حالة الغياب عن الوجود ولقاء الحبيب, هذه المفردات يُرمز بها إلى الذات العليا, وهذه رموز هي تمظهر المحبة الأزلية بمظاهر الآثار الكونية التي تعكس هذه المحبة, فالضياء تجلّيات إلهية في قلوب الذاكرين, والشمس هي محبة الإله وإشراق لطفه, وعلى هذه الرموز اتكأ في قصيدته ( خمرة المعنى) ليؤكد معنوية وروحية السكر الصوفي, في حضرة صوفية شتوية :
يَسْتَحِيْلُ العَصِيْرُ ضِياءً
في حَبَّاتِ العِنَبِ
حَيْثُ الشَّمْسُ قد أَفاضَتْ على الكُرُوْمِ العَطايا
وفي أَماسِيِّ الشِّتاءِ الباكِيةِ
نَحْتَسِيْها صُحْبةً
حَيْثُ المَعاني الباذِخةْ
فتَصْحُو في أَعْماقِنا
جُذْوةٌ مُتَّقِدةْ…
رمز الطبيعة: أن رمز الطبيعة هو تعبير عن جمال الذات الإلهية وجمال خلقها وإبداعها. وهي تشمل كل الرموز الكونية التي تستقي عناصرها من منابعها الطبيعية في عالمنا المحسوس: مثل الأرض, وما عليها من حيوانات ونباتات وأشجار وماء, إضافة إلى الطيور, تعتبر الفراشة أهم هذه الرموز وأميزها:
الفراشة :
انصهرت صورة الفراشة في الرمز الصوفي من خلال الظاهرة عشقها للضوء واحتراقها باللهب, وقد ارتبط تصرف الفراش المهلك هذا بالمعتقد الصوفي القائل بإمكانية الفناء والانصهار في الذات الإلهية, وتجسيد رحلة روح المتصوف وتلاشيها في الجمال الإلهي رمزيًّا في رحلة الفراشة إلى اللهب, فالتحوّل في الصورة الشعرية وجهة الرمز تعد خفقة أساسية في النبض الإبداعي الأدبي, حيث تتجسد المجردات في صورة حسية ملموسة ومرئية.
الفَراشةُ قَلْبي
يَتَلاشى طَيَرانُها
مَعَ الوُصُوْلِ
حِيْنَها تَخْسَرُ سَوادَ أَجْنِحَتِها
ويَبْتَلِعُها البَياضْ…
بَعْدَ الوُصُوْلِ لَنْ تَقْرُبَ كَثِيْراً مِنَ الشُّعْلةِ
ففي ذاتِها يَسْرِي نُورْ…
كما استخدم رمز الماء ورمز الريح ورمز الطير ورمز الشجر, وكلها رموز صوفية لها دلالاتها الخاصة.
4- التناص:
التناص القرآني: مستخدم بكثرة, لقد أعاد الشاعر كتابة العديد من الآيات من النص القرآني الغائب بتوظيف فني عبر امتصاص الآيات الكريمة:
قَصِيْدةٌ في غَيْمة
بعَصايَ.. أَهُشُّ على قَطِيْعِ قَصائِدي
هنا امتص الشاعر الآية الكريمة : ( هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي) الآية 18 من سورة طه.
التناص الأسطوري: وعن دراية ومعرفة قام الشاعر منذر يحيى بتوظيف الميثولوجيا برموزها في نصه الشعري, جاعلًا النص مفتوحًا على الإيحاء والتأويل الدلالي الرمزي, من قصيدة عشبة الخلود:
أَيَّتُها الأَفْعى المُخاتِلةُ
ماذا صَنَعْتِ بتِلْكَ العُشْبةِ المُرْتَجاةِ
التي أَضْنَتْ “جلجامشَ” في مَسارِهِ الطَّوِيلْ؟.
مُؤَكَّدٌ، راقَكِ أَنْ يَلْحَقَ بصَدِيْقِهِ ” أنكيدو”
التناص الأدبي : فإن الشاعر منذر يحيى, مفيدًا من ثقافته وقراءاته الكثيفة للمنتج الأدبي لمن سبقوه عبر حقب التاريخ, أو عاصرهم, ودرس تجاربهم الأدبية الناجحة, اختار أن يتناص معهم, عبر هذه التقنية الجمالية للتعبير من خلالها عن مكنوناته الشعورية والحسية, والأمثلة على ذلك عديدة نستعرض أمثلتها :
شَـغَافُ قَلْـبٍ حَزِيـن
على طَرِيْقةِ “سُوْفُوْكلِيْسَ”
لا تُوْقِظوا الحُبَّ بقَلْبي
فأنا الآنَ حُرٌّ أَسِيْرُ على هَوايَ
فقد امتص الشاعر عبارة سوفوكليس ووظّفها في قصيدته ( تداعيات خريف العمر), تعبيرًا عن معاناته الحب, ورأفة بقلبه الحزين المثخن بجراحه.
امتص الشاعر منذر يحيى ( الفتى – حجر) من قصيدة الشاعر الجاهلي تميم بن مقبل, التي بكى فيها زوجته التي فرقها عنه الإسلام, الذي ألغى العرف الجاهلي الذي يسمح بزواج الابن الأكبر من زوجة أبيه بعد وفاته, يقول :
ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر
تنبو الحوادث عنه وهو ملمومُ
كما أجده متناصًّا مع الشاعر الفلسطيني محمود درويش في رائعته المعنونة بنفس العبارة ( ليتني حجر) :
ليتني حجر
لا أُحنُّ إلي أي شيء
فلا أمسِ يمضي, ولا الغد ُيأتي
وظف الشاعر النمط التصويري الواقعي بسمته المأساوية التراجيدية, وهو يصوّر صراع الإنسان مع واقعه الذي تتناوشه مظاهر الشقاء, وانعدام الأمان, لا يخرج عن ذكر ( الروح) زاجًّا بها في أتون هذا الواقع الشقي:
وأنتَ تُصارِعُ الرِّيْحَ في زَمَنِ البَلْوى
حاذِرْ، الرُّوحُ تَئِنُّ تحتَ سِياطِ الحِقْدِ
والأمانُ المجروحُ يَهْجَعُ في رُكْنِهِ القَصِيِّ
كالأمِّ الثَّكْلى…
وفي شذرة (سرير القصيدة), مستخدمًا التصوير الذهني المجرّد, بسمة المواربة واللغة المجازية الرمزية, فالنفس أو الروح عند المتصوفة هي جوهر مادي من طبيعة إلهية, لذلك يصارع الصوفي للعودة إلى المبتدى يدفعه الشوق والحب, مستحضرًا وضع الموت:
عارِياً إِلّا مِنْ خَطيئاتي
أَسْتَلْقِي في سَرِيْرِ القَصيدةِ
كأنّي أَتَهَيَّأُ لعُبُوْرٍ أَكيدٍ
إلى مَمْلكةِ المَوْتْ…
بَطيئاً يَذُوْبُ جَسَدي الذي أَفْناهُ التَّشَهِّي
يُناوِرُ على طَريقتِهِ
كي يَصِلَ بأَمانٍ
إلى بَوّابةِ القِيامةْ…
من قصيدة ( خربشات, وأوراق قديمة), للخيال تصوير صوفي موظّف بدقّة في القصيدة, وهيمنة كبيرة لسمة الأمل والتحليق في الخيال على التصوير البلاغي, حيث القصيدة جسد قابل للاشتهاء, والحلم هوامش بكر, وهنا هيمنة واضحة للذات الشاعرة:
على جَسَدِ القصيدةِ
أَرُشُّ قَليلَ مِلْحٍ
وأَحْلُمُ بهوامشَ بِكرْ…
وفي قصيدة (قصب الرؤيا), هروب من الواقع الإنساني الشقي باتجاه الحلم والرؤيا, وهيمنة لسمة الأمل والحلم والتحليق الخيالي على التصوير البلاغي, فالشاعر هرب من عنت الواقع إلى أحضان القصيدة الحالمة, التي فتحت أفقها على جنّات فيها ما لذ وطاب, من موجودات حسية ومجازات بلاغية:
لأَسْتَرِيْحَ مِنْ عَنَتِ الوَقْتِ
أَطْرُقُ بابَ قَصِيْدتِكِ
يُفاجِئُني اللَّوْزُ بطَعْمِهِ الباذِخِ
كأُغْنِياتِ الجِبالِ
ويُعْلِنُ الرَّبِيْعُ
قِيامةَ الأَرْضِ
بِساطاً مُوشَّىً بقَصَبِ الرُّؤْيا
ووَرْدِ المَجازْ…
تتجلى سمة الدرامية في شقاء النفس الشاعرة الصوفية, ومأساتها في علاقتها بذاتها وبالآخر والوجود, وتردّده بين المادة والروح, وتأرجحه بين الذات والواقع, وإحساسه بالمعاناة والتوتر والجدل, وشعوره باالمأساة المتولدة من وجوده.
وهناك الكثير من التساؤلات والطروحات الفلسفية نجدها في القصائد والشذرات, كلعا تدخل ضمن فلسفات: الموت والحياة- الحب- البدايات – الأخرويات- العدد- الحضور والغياب – الجسد- الشك- الحزن ….إلخ
إن الشاعر منذر يحيى سلك مسلك الشاعر الصوفي بتوظيف الشذرات والشعر النثري الحر المعاصر, والتجريد الرمزي والإيحائي, مدعمًّا بالتقنيات التصويرية اللغوية البيانية والبلاغية, وأجاد في التصوير البلاغي بما حمّله من أمل وحلم إنساني مفتوح على الإيمان بالله والفناء في محبته و الدعوة إلى كسب رضاه, محققًا جمالية هائلة لنصوصه بلغته التعبيرية والتصويرية والتأثيرية والتواصلية, مع كل ما سندها من سمات التصوير الصوفي ومكوناته التجريدية والحسية والتخييلية والتشخيصية والتجسيمية, ما مكّنه من الإمساك بجوهر التجربة الصوفية في فرادتها وفي جماليتها.
#سفيربرس _ بقلم : د. عبير خالد يحيي



