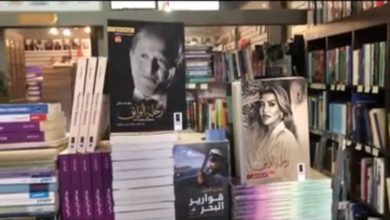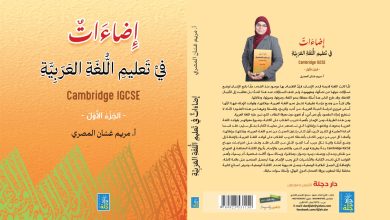منهجية العمل الصحفي في المراحل الانتقالية: سوريا نموذجاً.. بقلم : الإعلامي حسين الإبراهيم
#سفيربرس

في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، يتبوأ الإعلام دورًا استراتيجيًا بوصفه أداة للرقابة والمساءلة وإعادة تشكيل الخطاب العام. فلا تقتصر الصحافة الانتقالية على نقل الأخبار، بل تتجاوز ذلك إلى بناء أسس الديمقراطية وتعزيز الحوار المجتمعي. وتبرز هنا أهمية المنهجية الصحفية التي تضمن الاستقلالية والمهنية، خاصة عندما يكون الإعلام قد تعرض سابقًا للهيمنة السلطوية.
تحرير الإعلام من إرث التضليل وبناء سرديات الوحدة
تشكّل تجربة الإعلام السوري نموذجاً صارخاً لتحوُّل وسائل الإعلام من أداة سلطوية لتكريس الاستبداد إلى فضاء مُشظّى يعكس تعقيدات المرحلة الانتقالية. لكن الانتقال من إعلام “الثورة المضادة” إلى إعلام “ما بعد الصراع” يتطلب مواجهة أسئلة جوهرية تُحطّم إرث التضليل وتعيد تعريف دور الصحافة كجسرٍ للحوار الوطني.
1. الإرث الثقيل: من إعلام السلطة إلى فوضى الروايات
خلال عقود مضت، تحوّل الإعلام السوري إلى بوقٍ للدعاية، يُقدِّم صورةً ورديةً عن واقعٍ مُزيَّف، بينما يُجرم أي صوتٍ مغاير. بعد 2011، انفجر المشهد الإعلامي إلى منصات مستقلة، لكن الحرب حوّلتها إلى ساحاتٍ لصراع الروايات:
• إعلام النظام: استمر في تهميش المعاناة الإنسانية، ووصف الثورة بـ”المؤامرة الإرهابية”.
• إعلام المعارضة: ركز على جرائم النظام، لكنه تجاهل في كثيرٍ من الأحيان انتهاكات الفصائل المسلحة.
• الإعلام الدولي: تعامل مع سوريا كساحة لصراع جيوسياسي، مُحوِّلاً الضحايا إلى خلفيةٍ لأجنداته.
هذا التشرذم يطرح سؤالاً محورياً:
كيف يُعاد بناء إعلام سوري يعترف بتنوع الروايات دون أن يتحول إلى منصةٍ لاستمرار الصراع؟
2. أسئلة التحرير: كيف نتجاوز ثقافة التضليل والانقسام؟
أ. تفكيك إرث “الإعلام الأحادي”
• كيف يُمكن نزع الشرعية عن الخطاب الإعلامي السلطوي الذي روّج لـ “قدسية الرئيس” لعقود؟
• ما آليات محاسبة مؤسسات إعلام النظام على دورها في تبرير القمع، كما حدث مع إعلام نظام ميلوسيفيتش في صربيا بعد سقوطه؟
ب. مواجهة “فيروس” خطاب الكراهية
• كيف نمنع تحول الإعلام المستقل إلى ناقلٍ لخطابٍ طائفي أو انتقامي، كما حدث في الإعلام الليبي بعد 2011؟
• هل يمكن استلهام نموذج “لجنة الحقيقة والمصالحة” في جنوب أفريقيا، التي فرضت على الإعلام التزاماً بخطاب المصالحة؟
ج. إعادة تعريف المهنية: ما معنى “التوازن” في سياقٍ مشحون؟
• كيف نوفق بين واجب كشف انتهاكات النظام والمعارضة، دون الوقوع في فخ “التعادلية الزائفة” التي تعامل الجلاد والضحية كطرفين متساويين؟
• ما حدود استخدام لغة الصراع (مثل “النظام” و”الإرهابيين”)، وهل يمكن استبدالها بمصطلحاتٍ تعكس الواقع دون تأجيج الانقسام؟
3. نحو صحافة الحوار: تجارب مُلهمة وتحديات محلية
أ. دروس من التاريخ السوري نفسه
في خمسينيات القرن الماضي، شهدت سوريا تجربة إعلامية تعددية (pluralistic) نادرة، مع صحف مثل “الأيام” التي جمعت أطيافاً فكرية متنوعة. كيف يمكن استعادة هذا الإرث المنسي في ظل واقعٍ أكثر تعقيداً؟
ب. نماذج دولية: إصلاح الإعلام كجزء من العدالة الانتقالية
• البوسنة: بعد حرب التسعينيات، أُجبرت وسائل الإعلام على تبني مدوَّنة أخلاقية تمنع الخطاب العرقي، بدعم من المجتمع الدولي. هل يُمكن تطبيق هذا في سوريا رغم اختلاف السياق؟
• كولومبيا: أنشأت “لجنة سلام وإعلام” لمراقبة تغطية الصراع، وتدريب الصحفيين على لغةٍ تعزز السلام. كيف نضمن ألا تتحول المبادرات إلى أدواتٍ للرقابة الجديدة؟
ج. التضامن الاجتماعي: عندما يصبح الإعلام منصةً للفئات المهمشة
• كيف تُعطى مساحةٌ لأصوات النساء، النازحين، والأقليات (كالكرد والسريان وغيرهم)، الذين ظلوا خارج الخطاب الإعلامي المركزي؟
• ما دور الإعلام في تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية، مثل جهود أهالي درعا لإعادة إعمار المدينة دون انتظار الدعم الحكومي أو الدولي؟
4. آليات عملية: من السؤال إلى التطبيق
لتحرير الإعلام السوري من إرثه، لا بد من خطوات ملموسة:
• إصلاح قانوني: إلغاء القوانين القمعية (كقانون المطبوعات 2011)، وتبني تشريعات تضمن حماية الصحفيين واستقلالية الإعلام، كما في دستور تونس 2014.
• مبادرات ذاكرة جماعية: إنشاء أرشيفٍ وطنيٍ رقمي (كدور “متحف الذاكرة” في تشيلي) لتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات من جميع الأطراف، كأساسٍ لمصالحةٍ تعترف بالضحايا.
• تحالفات إعلامية: بناء شبكاتٍ تضم منصاتٍ من مناطق النفوذ المختلفة (نظام، معارضة، مناطق كردية)، لإنتاج محتوى مشترك حول قضايا مشتركة (كالتعليم، الصحة، البيئة).
• التعليم الإعلامي: تدريب الصحفيين على “صحافة السلام”، وإدراج مناهج تعليمية في المدارس لتعليم النشىء كيفية تحليل الخطاب الإعلامي، كما فعلت المغرب في مبادرة “مواطنون ضد التضليل”.
الصحافة كفعل مقاومة للنسيان
الانتقال الإعلامي في سوريا ليس مجرد تغيير في “ملاك المؤسسات” أو خطابها، بل هو معركةٌ ضد نسخةٍ من التاريخ سُوِّقت لعقود، وضد ثقافةٍ استسهلت تحويل الإنسان إلى رقم في صراعٍ لا ينتهي. الأسئلة المطروحة هنا ليست أكاديمية، بل مصيرية: فبدون إعلامٍ يعيد ربط السوريين ببعضهم، ويحوّل الحوار من “نداءات الانتقام” إلى “حكايات التعافي”، سيظل السلام مستحيلاً.
قد تكون الإجابة الأكثر إلحاحاً هي أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون: التاريخ لا يعيد نفسه، لكن الصحافة قادرة على تغيير طريقة سرده.
تحديات الانتقال المجتمعي: بين الحرية والمسؤولية
تواجه الصحافة في المراحل الانتقالية تحديات متشابكة:
• الأمني: استهداف الصحفيين، كما حدث في سوريا مع اغتيال ناشطين إعلاميين.
• القانوني: غياب تشريعات تضمان استقلالية الإعلام، أو وجود قوانين قمعية كتلك المُستخدمة في مصر.
• الاقتصادي: صعوبة استدامة المنصات المستقلة في ظل غياب التمويل الآمن، حيث تعاني بعض الدول من هيمنة رجال الأعمال على الإعلام.
• الثقافي: إعادة بناء ثقة الجمهور بعد عقود من الإعلام الدعائي.
من صحافة السلطة إلى الصحافة البناءة: نحو سرديات تُصلح ما أفسدته الحروب
في المراحل الانتقالية، تتحول الصحافة من أداة لتكريس الصراع أو تبرير السلطة إلى فضاء لبناء السلم المجتمعي. ففي سوريا، حيث طُبعت عقود من الإعلام الرسمي بخطابٍ أحادي يُجَمل القمع ويُخفي المعاناة، تبرز الحاجة إلى نموذج صحفي يعيد ربط الشرائح المتنافرة عبر سرديات تركز على الحلول، لا على إثارة النزاعات. هنا، تظهر “الصحافة البناءة” (Constructive Journalism) كبديلٍ جذري، لا يُنكر الواقع المأساوي، لكنه يبحث عن طرقٍ لتجاوزه.
بين الصحافة البناءة و”صحافة الصراع”
تعتمد “صحافة الصراع” التقليدية على تسليط الضوء على العنف والانقسامات لاجتذاب الجمهور، مما يُعمِّق الشعور باليأس ويُغذي الاستقطاب. في سوريا، مثّلت التغطية الإعلامية الدولية للحرب تركيزاً مُفرطاً على المعارك الدموية وتفاصيل الصراع الجيوسياسي، بينما غُيِّبَت قصص المبادرات المحلية لإعادة الإعمار أو جهود المصالحة بين المجتمعات.
الصحافة البناءة تُعيد التوازن عبر:
• الانتقال من “ماذا حدث؟” إلى “كيف نصلح؟”: مثل تقارير منصة “بدايات” السورية عن مشاريع إعادة تأهيل المدارس في إدلب، بدلاً من الاكتفاء بتوثيق القصف.
• إبراز قصص النجاح الصغيرة: كتجربة نساء درعا في إنشاء تعاونيات زراعية رغم الدمار.
• تجنب التضخيم الإعلامي للخطاب الكراهية: كما حدث في رواندا ما بعد الإبادة، حيث حوّلت وسائل الإعلام النقاش من “التقسيم العرقي” إلى “كيف نمنع تكرار المأساة؟”.
تجارب عالمية: دروس للمنطقة العربية
1. رواندا: إعلام المصالحة بدل إعلام الكراهية
بعد الإبادة الجماعية (1994)، فرضت الدولة سياسات إعلامية صارمة لمنع الخطاب العنصري، لكنها أيضاً دعمت برامج مثل “إيكيغاني” (Ikigani) على راديو رواندا، الذي يروي قصصاً عن ضحايا من التوتسي والهوتو معاً، مع طرح أسئلة مثل: كيف نعيش كجيران بعد أن قتل أحدنا عائلة الآخر؟. هذا النموذج حوّل الإعلام من مُحرض إلى جسر للتفاهم.
2. تونس: صحافة الحلول في مواجهة الاستقطاب
بعد الثورة، ركزت منصات مثل “إنكفاضة” على تقارير استقصائية حول الفساد، لكنها اقترنت بمساحات للحوار العام، مثل برنامج “شكون؟” (من المسؤول؟)، الذي يناقش سياسات الدولة مع الخبراء والمواطنين، ويطرح بدائل عملية.
3. كولومبيا: صحافة السلام بعد اتفاقية “هافانا”
أطلقت مؤسسة “فاكتوم” مشروع “صوتيات السلام”، الذي ينشر قصصاً صوتية عن ضحايا الصراع المسلح من جميع الأطراف، مع التركيز على مبادرات التعايش في القرى التي عانت من احتكار الميليشيات.
الصحافة البناءة في سوريا: محاولات هشة وتحديات معقدة
رغم الظروف القاسية، تظهر مبادرات سورية تُعيد تعريف دور الإعلام:
• منصات تركز على الحلول: مثل “سوريا على طول” التي تُوثق مشاريع إدارة النفايات في مخيمات النزوح، أو “الحلقة السورية” التي تنظم حواراتٍ بين مثقفين من مناطق سيطرة النظام والمعارضة.
• صحافة البيانات لخدمة التنمية: استخدمت منظمة “أيام سورية” تحليلات البيانات الجغرافية لتحديد مناطق الجفاف وربطها ببرامج الإغاثة.
• توظيف الفنون في السرد الإعلامي: مبادرة “فنانون من أجل سوريا” تدمج الرسوم الكاريكاتيرية والمسرح التفاعلي في نقل قصص النازحين، بعيداً عن لغة الاتهام.
لكن التحديات تظل هائلة:
• السياقات الأمنية: استهداف السلطة للمبادرات الإعلامية المستقلة.
• التمويل المشروط: تحوُّل بعض المنصات إلى أدوات لجهات مانحة تفرض أجنداتها.
• الجمهور المشتت: صعوبة بناء قاعدة جماهيرية واسعة في ظل انقسام البلاد.
كيف تُعزز الصحافة البناءة المصالحة؟
1. تحويل الضحايا إلى فاعلين: بدلاً من تقديم السوريين كأرقام في تقارير المعاناة، تسلط الصحافة البناءة الضوء على مبادرات مثل “جمعية أبناء درعا” التي تجمع تبرعاتٍ لإعادة بناء المنازل المدمرة، بغض النظر عن انتماءات أصحابها.
2. خلق مساحات للحوار الافتراضي: استخدام منصات مثل “زوم” أو تطبيقات مخصصة (كمنصة “حوار” السورية) لتنظيم نقاشات بين سوريين من الداخل والخارج، بإشراف مختصين في حل النزاعات.
3. ربط الإعلام بالعلوم الاجتماعية: التعاون مع باحثين لتحليل أسباب الصراع واقتراح سياسات بديلة، كما فعلت “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عند إصدار تقارير عن إعادة إدماج المقاتلين السابقين.
التقنيات الحديثة في خدمة الصحافة البناءة
• الذكاء الاصطناعي لرصد الفرص: مثل أداة “سلام-بوت” التي طورها نشطاء سوريون لرصد المبادرات المحلية الصغيرة في مناطق النزاع، وتوصيلها بجهات التمويل.
• الواقع الافتراضي لنزع “تأثير المتفرج”: إنتاج قصص تفاعلية تُظهر للجمهور كيف يمكن لتدخلات بسيطة (كحفر بئر ماء) أن تُغيّر حياة مجتمع بكامله.
• منصات بلوك تشين لتمويل المشاريع: كما في مبادرة “الإعلام التشاركي” في اليمن، التي تستخدم العملات الرقمية لدعم تقارير صحفية عن إعادة الإعمار دون تدخل جهات متحيزة.
الصحافة البناءة… إعادة تعريف المهنة
الصحافة البناءة ليست مجرد “نوع صحفي”، بل هي فلسفة تُعيد تعريف دور الإعلام في المجتمعات الهشة: من كونه مرآةً تعكس التشقق إلى مطرقةٍ ترمم الجدران. في سوريا، حيث قد يستغرق البناء عقوداً، يمكن لهذا النموذج أن يتحول إلى خريطة طريق لإعادة الحياة إلى المدن، ليس بالأسمنت فقط، بل بالثقة بين البشر. النجاح يتطلب شراكةً بين الصحفيين والأكاديميين والتكنولوجيين والمجتمعات المحلية، لصنع سردياتٍ تُخرج السوريين من دائرة “الضحايا” إلى فضاء “الصنّاع”.
التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي: تأهيل، تمكين، إبداع، ودعم المصالحة
في سياق المراحل الانتقالية، لا تقتصر أدوار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على نقل المعلومات فحسب، بل تُشكِّل ركيزةً لإعادة بناء النسيج المجتمعي عبر تمكين الصحفيين، وتحفيز الإبداع، وتعزيز الحوار الوطني. فيما يلي تفصيل لهذه الأدوار مع نماذج تطبيقية:
1. التأهيل والتدريب: بناء جيل جديد من الصحفيين “الرقميين”
أصبحت منصات التعلم الذكية والواقع الافتراضي (VR) أدوات حيوية لتأهيل الصحفيين في المناطق المُدمَّرة أو ذات الإمكانيات المحدودة، كما في سوريا:
• منصات تعليمية مخصصة: مثل مبادرة “صحفيون بلا حدود” التي أطلقت دورات عبر الإنترنت بالشراكة مع منظمة “اليونسكو”، تركّز على مهارات التحقق من المعلومات والأمن الرقمي، مستخدمةً خوارزميات ذكية لتكييف المحتوى مع احتياجات المتعلمين.
• محاكاة الواقع الافتراضي: في رواندا، يُستخدم VR لتدريب الصحفيين على تغطية النزاعات بحساسية، عبر محاكاة سيناريوهات شبيهة بالإبادة الجماعية، مما يُعزِّز فهمهم لتأثير الكلمات على المصالحة.
• الشبكات العصبية للتدريب اللغوي: في مجتمعات متعددة الثقافات مثل سوريا، تُساعد أدوات الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (كأداة “ديب إل”) الصحفيين على إنتاج محتوى بلغات محلية (كالكردية والسريانية)، لضمان شمولية الخطاب الإعلامي.
2. التمكين: أدوات ذكية لدعم الصحافة المستقلة
يُمكّن الذكاء الاصطناعي الصحفيين من تجاوز العقبات التقليدية عبر:
• تحليل البيانات الضخمة: استخدمت منصة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” (STJ) خوارزميات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، عبر تحليل آلاف مقاطع الفيديو والوثائق، مما وفّر أدلةً قضائيةً ودعماً للضحايا.
• أتمتة المهام الروتينية: في تونس، طوّرت جمعية “صحفيون تونسيون” أداة “صحفي-بوت” لتحويل البيانات الحكومية إلى تقارير مالية مبسطة، مما وفّر وقت الصحفيين للتركيز على التحقيقات الاستقصائية.
• حماية المصادر: تُستخدم تقنيات التشفير المتقدمة (كمنصة “سيغنال”) ونظم حذف البيانات التلقائي (مثل “وايب ماي تاريخ”) لحماية هويات المصادر في المناطق الخطرة.
تحفيز الإبداع: من القصص التفاعلية إلى الفن الصحفي
أصبحت التقنيات الحديثة حاضنةً لإبداعات صحفية غير تقليدية تعكس تعقيدات المراحل الانتقالية:
• الصحافة الغامرة (Immersive Journalism): في لبنان، استخدمت منصة “دارج” تقنية الواقع المعزز (AR) لإنتاج قصص تفاعلية عن النازحين السوريين، مدمجةً بين الصوت والصورة والخريطة الذكية، لتعزيز التعاطف مع قصصهم.
• الذكاء الاصطناعي الإبداعي: تجربة وكالة “فرانس برس” في استخدام أداة “دال-إي” لتحويل النصوص إلى صور فنية تسرد تاريخ الثورة السورية بشكلٍ مرئي، مما يساهم في توثيق الذاكرة الجمعية.
• بودكاست تفاعلي: في كولومبيا، أطلقت منصة “كونكورديا” بودكاستاً يستمع إلى آراء المستمعين حول اتفاقية السلام عبر الذكاء الاصطناعي، ويُعيد إنتاج حلقاتٍ تعكس تطلعاتهم.
4. توظيف الإعلام الرقمي في تحصين المصالحة الوطنية
يمكن للتكنولوجيا أن تكون جسراً بين المجموعات المتنازعة عبر:
• منصات الحوار الافتراضية: في العراق، أطلقت منظمة “نداء السلام” منصةً رقميةً تجمع ناجين من تنظيم داعش وضحاياهم في حواراتٍ مُدارةٍ بالذكاء الاصطناعي، تُرشِّد النقاش وتحدّ من خطاب الكراهية.
• تحليل المشاعر لقياس الرأي العام: في سوريا، تعمل منظمة “أرشيف الثورة السورية” على تحليل التعليقات على وسائل التواصل باستخدام خوارزميات NLP لفهم مخاوف المجتمعات المحلية، وتوجيه الحملات الإعلامية نحو تعزيز الثقة.
• مبادرات الفنون الرقمية: كتجربة “فن من أجل السلام” في رواندا، حيث استُخدمت تقنية البلوك تشين لتوثيق أعمال فنية تعكس روايات الناجين، وتحويلها إلى رموز رقمية (NFTs) تُموّل مشاريع المصالحة.
التحديات والضوابط الأخلاقية
رغم الإمكانات الهائلة، يجب التعامل مع التقنيات بوعي لتجنب مخاطر:
• التحيُّز الخوارزمي: قد تُكرّس أدوات الذكاء الاصطناعي انقساماتٍ إنْ تم تدريبها على بيانات غير متنوعة (كحالة خوارزميات فيسبوك في ميانمار).
• التضليل عبر التكنولوجيا العميقة: كاستخدام “الديب فيك” لنشر أخبار كاذبة عن مفاوضات السلام.
• الهيمنة التكنولوجية: اعتماد معظم المنصات السورية على تمويل خارجي يعرّضها لشروطٍ قد لا تخدم الأولويات المحلية.
متطلبات النجاح:
• تطوير أطر أخلاقية لإدارة الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بالشراكة مع منظمات دولية مثل “اليونسكو”.
• دعم تطوير تقنيات محلية مفتوحة المصدر، كمنصة “جسور” السورية للصحافة الاستقصائية.
• إشراك الناجين والمجتمعات في تصميم الأدوات التقنية لضمان تمثيل أصواتهم.
تقنيات تُحوِّل التحديات إلى فرص
التجارب من سوريا ورواندا إلى تونس تُثبت أن التكنولوجيا ليست محايدة، بل هي انعكاس لإرادة البشر في استخدامها. عندما تُوظَّف لدعم التأهيل والتمكين والإبداع، تُصبح أداةً لتحصين السلم الأهلي، وكتابة سرديات جديدة تعيد تعريف “العدو” من الإنسان إلى الفساد والكراهية. الصحافة الانتقالية المدعومة بتقنيات ذكية ليست رفاهية، بل ضرورة لإنقاذ الذاكرة، وبناء المستقبل.
دور الصحفي: من ناقل أخبار إلى مؤثر في تحصين عملية التغيير
في المراحل الانتقالية، يتحول الصحفي من مجرد مراسل إلى “حارس للقيم الاجتماعية”، عبر:
• التحقق من المعلومات: مواجهة الشائعات في سياق تشظي الحقائق، كما في الحرب السورية.
• حماية الضعفاء: إعطاء صوت للمهمشين، كضحايا التعذيب في سجون النظام السوري.
• الشفافية: كشف الفساد في مراحل الانتقال، كما فعلت صحف تونسية بعد الثورة.
• التدريب المستمر: اكتساب مهارات في الأمن الرقمي والصحافة الاستقصائية.
نحو منهجية متكاملة
تقدم سوريا نموذجاً معقداً للانتقال الإعلامي، حيث تتداخل الحرب والثورة والتدخلات الخارجية. لكن الدروس الدولية تُظهر أن النجاح يتطلب:
1. إطاراً قانونياً يحمي استقلالية الإعلام.
2. دعم المنصات المستقلة اقتصادياً.
3. تكوين جيل من الصحفيين المدربين على أخلاقيات المهنة والتقنيات الحديثة.
4. تعاون دولي لمواجهة التضليل دون انتهاك السيادة.
بذلك، تصبح الصحافة جسراً من الحرب إلى السلام، ومن الاستبداد إلى المواطنة.
#سفيربرس _ بقلم : الإعلامي حسين الإبراهيم