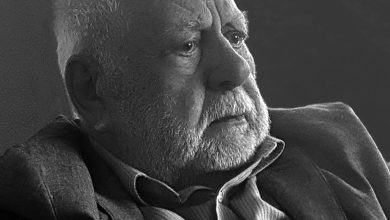سفيربرس ..في حضرة حوار “وفيق صفوت مختار”: حلّق في سماوات الطفل وفضاء البورتريه الصحفي .. استنزف الروائي “خيري شلبي.. وهذه أمنيته …
#سفيربرس _ إعداد وحوار : هبة عبد القادر الكل

من السّهل جداً أن أصفَ الشّمس وأترنّم بأسرار نورها وإشراقها وسط الغيوم والضّباب، ولكن كيف لي أن أقدّمها لكم!
هذا ما حصل معي تماماً، فكيف لي أن أُقدّم شمساً من شموس الكتابة، قمراً من أقمار الرسالة الخبرية وكوكباً من كواكب صاحبة الجلالة، وهو ابنُ أميرة من أميرات الفراعنة وشيخُ مربيها، الذي اتّخذ من شاطئ التنوير والتثقيف مرفأ ليراعه الرشيد، بعد مسير إبحار شاق ومجيد في عالم الطفولة والصحافة معا، لأنّه المؤمن بحقّ البشرية في الحياة، والموقن بأنّ الكتابة ليست نصّاً أدبياً وحسب، بل هي محاولة للسيطرة على القيم الثابتة في عصرنا المتحرك …
لا أُخفيكم فضولي الصحفي للنبش في ذاكرة المبدعين وتأريخها كان قائدي لحواره، بعد وقوعي على إحدى مقالاته التي جذبتني أيّما جذب، علّني أنهل من شغفه بالحرف والكلمة ما أتنوّر به أكثر.. وهو الذي لم يبخل عليّ بجواب ولا تذمّر من سؤال، بل كان سمحاً، كريماً، وقوراً، وصادقاً، .. فنلتُ شرف محاورة كبير الأخصائيين التربويين في جمهورية مصر الشقيقة «وفيق صفوت مختار» على أمل أن أكون قد وُفّقتُ فيه لما فيه من الفائدة لكم أعزّتي القُرّاء:
في حضرة الحوار مع الكاتب، المؤلِّف والباحث «وفيق صفوت مختار»، ماذا يعني لكَ الحوار؟
هُو نبشٌ في الذَّاكرة لاسترجاع مواقف وحكايات قد أكُون قد نسيتها بفعل تراكُم الأحداث الَّتي مرَّت بي على مدار سنواتٍ طويلةٍ مِنْ مُكابدة النَّفس والكفاح ضِدّ المُشكلات الجمَّة الَّتي واجهتني على مدار مسيرةٍ طويلةٍ لم تعرف الكلل أو الملل.. وأنا بهذه المُناسبة أشكُركِ على هذه المُبادرة الطَّيِّبة..
كيف يُحبُّ أنْ يُقدِّم «وفيق صفوت مختار» نفسه لجُمهُور القُرَّاء؟
أنا مَنْ آمن بإنسانيَّة البشر، وحقُّهم في الحياة اللَّائقة الَّتي تحترم إرادة الله سُبْحانهُ في خلقهم، أنا مَنْ أحبّ العالم مِنْ حوله، دُون تمييز أو عُنْصُريَّة، أنا مَنْ اعتنق فكرة الفيلسوف الصِّيني «كُونفُوشيُوس»، التي تقُول: «بدلًا مِنْ أنْ تلعنُوا الظَّلام أضيُئوا شمعة»، أنا الَّذي اتَّخذ مِنْ القراءة ملاذًا آمنًا لكي احتمي بها مِنْ كُلِّ النَّوائب والمصاعب الَّتي واجهتني، وفي مرحلةٍ لاحقةٍ اتَّخذت مِنْ الكتابة رسالة كي أنشُرها بين النَّاس هدفها التَّنوير والتَّثقيف، قد أكُون حقَّقت ما أصبُو إليه.. وقد أكُون فشلت، ولكنِّي أديت كُلّ ما أملاه عليَّ ضميري..
لنبدأ إبحارنا مِنْ شطِّ أميرة مِنْ أميرات الفراعنة «طهطا»، تنشئةً وتربيةً؟
وُلدت في مدينةٍ هادئةٍ أحببتُها رغم كُلّ شيء.. مدينة «طهطا» إحدى مُدُن مُحافظة «سُوهاج»، بصعيد مصر، في بيتٍ عتيقٍ ورثه أبي عن أجداده، كُنت المولُود الأوَّل في العائلة فكانت الفرحة لمقدمي كبيرة وغامرة، وكانت جدَّتي لأُمِّي تُؤْثرني ولا تتحمَّل أنْ تراني مُتعبًا أو مُرهقًا، استطاعت الأُسرة توفير كُلّ ما يجعلني أنْ أعيش طُفولة هادئة وادعة، التحقت بمدرسة «الرَّاهبات» ثُمَّ انتقلت إلى مدرسة «أرثر هيوز» الخاصَّة لاستكمال تعليمي الابتدائي، حيث حصلت على الشَّهادة الابتدائيَّة في عام (1969 م)، بمجموع )84)%، وهُو مجموع كان كبيرًا في ذلك الوقت.. وفي أثناء هذه المرحلة – الأهمّ في حياتي – تعرَّفت على القراءة عندما بدأت أُجيدُها، كُنت أعين مندُوبًا ثقافيًّا لفصلي الدِّراسي حيث أقوم بمهمَّة أمين المكتبة داخله.. كما كنت أحرص على اقتناء مجلَّة «سمير»، ومجلَّة «ميكي» للأطفال، أيضًا كُنت أحد أعضاء الإذاعة المدرسيَّة فأنا مَنْ يُلْقي نشرة الأخبار التي أقُوم بإعدادها مِنْ جريدة «الأهرام» القاهريَّة. أمَّا في المرحلة الإعداديَّة فقد أضفت إلى هواية القراءة هواية جديدة هي: «الرَّسم»، وهكذا كُنت اقضي يومي الدراسي ما بين المرسم والمكتبة، أمَّا في المرحلة الثَّانويَّة فقد تنوَّعت مصادر القراءة لديَّ، بدأت في الصَّفِّ الأوَّل الثَّانوي بقراءة كتاب «قاهر الظَّلام» للكاتب «كمال الملَّاخ»، حيث يروي محطَّات من حياة عميد الأدب العربي الدُّكتُور «طه حُسين»، ومِنْ يومها اتَّخذت هذا الأديب قُدوة لي، فقرأت له ضمن ما قرأت رائعته: «الأيَّام». أمَّا في المرحلة الجامعيَّة فقد تنوَّعت قراءاتي من أدب عربي ومُترجم، وعلم نفس، وفُنُون تشكيليَّة، وفلسفة، وتاريخ، وتراجم، وغيرها.. هذه هي البدايات الَّتي كانت مُقدمة منطقيَّة لحياتي بكاملها…
حضرتك مِنْ الأخصائيين التَّربويِّين في جمهوريَّة مصر العربيَّة، ما منهجُك التَّربوي النَّفسي الخاصّ بك؟
مُنْذ حصلت على الدِّبلوم الخاصّ في التَّربية عام (1984م)، بعد تخرُّجي في كُلِّيَّة التَّربية بأربع سنواتٍ وأنا بدأت في البحث المُتأني العميق عن عالم الطُّفولة، هذا العالم الَّذي أحببتُه مِنْ خلال تلك الدِّراسة، كُنت متفوقًا للغاية في مجال علم نفس النُّمو الخاصّ بالطفل، لدرجة أنَّ الدُّكتُورة الَّتي كانت تقُوم بالتَّدريس لنا في مرحلة الدِّراسات العُليا كانت تخُصُّني بأنْ أجلس بالقرب منها لكي أُساهم بما أعرفه مِنْ معلوماتٍ في هذا الفرع على زملائي، وهُو ما حفَّزني – فيما بعد – على الكتابة عن هذا العالم الثَّري والمُدهش، بالطَّبع كان منهجي علمي بحت يبدأ بتحديد المُشكلة حتَّى الوصول إلى أفضل الحُلُول المُمكنة. بالإضافة إلى المنهج الوصفي وكذلك المنهج التَّحليلي.
برأيك: متى تُسبَّب البرامج التَّربويَّة خللًا في مستويات التَّربية ؟
عندما تكُون تلك البرامج مُستوردة مِنْ الخارج كما هي بلا تعديل أو تبديل وفرضها على استراتيجيَّاتنا التَّربويَّة بحيث لا تتوائم أو تتوافق مع طبيعة الطِّفل العربي. فكم مِنْ تجارب مستُورة مِنْ الخارج فشلت فشلًا ذريعًا لأنَّها أغفلت بيئات هؤُلاء الأطفال وواقعهم البيئي والقيمي.
هل تُؤيد فكرة أنَّ البرامج التَّربويَّة المُنتقاة تُخفِّف مِنْ سطوة أنظمة العُنف والقُوَّة على الأفراد داخل المجتمعات؟
أستطيع القول بكُلِّ أمانةٍ أنَّ برامجنا التَّربويَّة الحاليَّة وممارستها داخل مدارسنا ومعاهدنا قد طويت صفحة العُنف البدني المُوجَّه إلى أفرادها، فقد تمَّ مُنذ سنواتٍ طويلةٍ منع كُلّ وسائل العُنف كالضَّرب مثلًا. وقد أصبحت التَّربية بمفهُومها الحديث تتمركز حول توفير أكبر قدر مِنْ الصِّحَّة النَّفسيَّة للطِّفل، وهو ما تُحاول المدارس تطبيقه من خلال توفير ما يعرف بالأخصائي النَّفساني الَّذي تكون وظيفتُه الأساس محاولة وضع يده على الأسباب النَّفسيَّة التي تدفع بعض التَّلاميذ للخُرُوج عن السُّلُوك السَّوي، ومِنْ ثمَّ وضع أفضل الحُلُول لتلافي هذه المُشكلات. وهذه الوظيفة المُستحدثة تختلف عن ما يعرف بالأخصائي الاجتماعي الَّذي تكون مهمَّتُه في المقام الأوَّل التَّعرُف على مُشكلات الأطفال الاجتماعيَّة ومحاولة حلِّها.
ما بين البرامج التَّربويَّة على أنواعها وبين إعداد المُربِّي الإعداد اللَّازم.. أين يقف حجر العثرة لترجمة مُفردات التَّربية على واقع أطفالنا؟
مِنْ أهمِّ الغايات الحديثة في التَّربية هُو إعداد المُربِّين والمُربِّيات للقيام بوظائفهم التَّعليميَّة والتَّربويَّة خير قيام، فقبل تطبيق أي برامج تربويَّة حديثة لابُدّ مِنْ تدريب هؤُلاء على أهداف وغايات ووسائل هذه البرامج.. إنَّ نجاح أي منهج تربوي أو تطبيق أي سياسة تربوية جديدة يعتمد في المقام الأوَّل على تدريب المُعلِّمين والمُعلِّمات.. لكنّ الَّذي يحصُل – غالبًا – هُو أنْ يتمّ تدريبُهُم بشكلٍ صُوري أو بشكلٍ سطحي مِنْ باب الحُصُول على شهادة تدريب وحسب.. وهذا ما يُسبِّب مُشكلات جمَّة عند تطبيق برنامج تربوي لا يؤمن بجدواه المُعلِّم.. ومِنْ هُنا يعجز عن إيصال ما يُريدُه حقًا البرنامج التَّعليمي المُستهدف.. وهُو ما ينعكس بالسَّلب على أطفالنا.. فكم مِنْ برامج تربويَّة فشلت بسبب عدم تهيئة المُربِّين أو المُربِّيات على الإيمان بهذه البرنامج.. اعتقد أنَّ منظُومة تدريب المُعلِّمين لابُدّ أنْ يُعاد النَّظر فيها بشكلٍ جذريٍّ.. فلقد وجدت أثناء خدمتي التَّربويَّة أنَّ الغالبيَّة مِنْ زملائي المُعلِّمين والمُعلِّمات لا يجدُون التَّعامل مع الوسائل التِّكنُولُوجيَّة الحديثة الَّتي مِنْ المُفترض استخدامها مع الاستراتيجيَّات التَّربويَّة والتَّعليميَّة الحديثة، بينما يُجيدُها تلاميذُهُم !!
لطالما كان الزَّرع لا يتحقَّق إلَّا باستجابة المُتلقِّي. كيف تُقيم استجابة جيل اليوم للزَّرع التَّربوي؟
سؤالٌ رائعٌ أُحيِّيكِ عليه.. علينا أنْ نُقرِّر في البداية أنَّ المناهج الدِّراسيَّة الحاليَّة الَّتي تستخدمها أغلب مدارسنا لا تجذب أطفالها بشكلٍ جيدٍ فهي مناهج تعتمد على الكم وليس على الكيف، هي مناهج جافَّة خالية من الإثارة والتَّشويق، كما أنَّ هذه المناهج تكُون طويلة بحيث لا تُتيح للتِّلميذ الفُرصة للاكتشاف أو استيعابها استيعابًا هادئًا مُؤثِّرًا، بل نراه يُحاول الإحاطة بها على عجلٍ لأنَّ الوقت ليس في صالحه، ليس هدفُه الاستمتاع بقدر ما يكُون تحصيل دراسي بهدف اجتياز امتحان آخر العام وفقط. هُناك أيضًا نُقطة في غاية الخُطُورة هُو أنَّ مُعظم مناهجنا وبالأخصِّ في العُلُوم تدرس بشكلٍ نظريٍ بحت دُون الالتفات إلى الجانب العملي، فمن المُهم جدا أنْ يرى التِّلميذ التَّجارب العلميَّة وهي تُجرى في المعمل، وهُو ما لا يحصل.. ولنقس على ذلك أشياء كثيرة.. من بينها أيضًا الوسائل التَّعليميَّة أو الوسائل المُعيّنة التي تقدَّم للتِّلميذ لكي يستطيع استيعاب بعض المُقرَّرات، فعندما نقُوم بتدريس معالم أثريَّة في منطقةٍ ما ضمن مادَّة التَّاريخ فلابُدّ أنْ تقُوم المدرسة برحلةٍ تعليميَّةٍ لزيارة هذه المنطقة الأثريَّة موضُوع الدِّراسة ، وهو الأمر الذي لا يحصل أيضًا.. لتكون المُحصِّلة في النِّهاية استجابة ضعيفة للغاية من أطفالنا تجاه كُلّ ما يُقدَّم إليهم مِنْ موادٍّ تعليميَّةٍ.
قد يحدث صدام أحيانًا بين الغرس التَّربوي للأُسرة، وبين الغرس التَّربوي للمدرسة أو المُحيط.. نتيجة اعتبارات واختلاف تصوُّرات وأهداف.. برأيك: كيف يُمكن أنْ نتعامل مع هذا الصدام بشكلٍ لا يُؤثِّر على أطفالنا ونفسيَّاتهم ؟
سؤالٌ على درجةٍ كبيرةٍ من الأهميَّة.. يحصُل بالفعل هذا الصدام نتيجة عدم تعاون المدرسة والمنزل، وانعدام الصِّلة بينهما، في معظم كُتُبي التَّربويَّة أُنادي بضرُورة أنْ يتمَّ التَّعاون الفاعل بين المدرسة مِنْ جهةٍ وبين البيت مِنْ جهةٍ أُخرى، وكُنْت أُدلِّل على ذلك بأمثلةٍ عديدةٍ، فقد يتدهور فجأة مستوى الطِّفل التَّعليمي أو التَّحصيلي فنرجع ذلك لعوامل، مثل: الإهمال والكسل أو ما شابه، ولكن عند الاتصال بالأُسرة ومعرفة أحدث مُستجدَّاتها يُمكنُنا اكتشاف الأسباب الحقيقيَّة وراء هذا التَّدهوُر وبهذا يكُون العلاج واقعيًّا ومِنْ ثمَّ ناجعًا. لكن الواقع الَّذي نعيشه الآن يعقد هذا الموقف عن ذي قبل، وذلك لأنَّ أعداد التَّلاميذ قد تزايدت بالفعل، بينما لم تزد أعداد المُعلِّمين أو الأخصائيِّين الاجتماعيِّين أو النَّفسانيِّين، ومِنْ ثمَّ هُناك عوائق في الاتصال والتَّعاون إلَّا في أضيق الحدود. وأنا أُنادي بضرورة أْن تعقد اجتماعات دوريَّة كُنَّا نسميها اجتماعات مجالس الآباء، بين أولياء الأُمور وأعضاء هيئة التَّدريس لمناقشة المُشكلات الَّتي تُواجه الأبناء بشكلٍ عامٍّ ومُحاوله إيجاد الحُلُول المُناسبة في حضرة الآباء والمُعلِّمين.. وبدُون هذا سوف تكُون هُناك فجوة لا يمكن ملء فراغها.. ممَّا سيُؤثِّر بالسَّلب على أبنائنا.
القارئ لمُؤلَّفاتك ومقالاتك، يلحظ الاهتمام الجمُّ الَّذي يُؤثرُه قلمُك غالبًا: «الطِّفل» وكُلُّ ما يتَّصل به تربويًّا ونفسيًّا.. هل يُمكنُنا أنْ نستشف أنَّ رُوح الطُّفولة البريئة هي «الغلَّابة الغالبة» عليك، أم لهي “المسؤُوليَّة”؟
أنا مِنْ أشدِّ المُؤمنين بأنَّ كُلَّ طفل يأتي إلى العالم وهو يحمل رسالة مفاداها أنَّ الله سُبحانه وتعالي لم ييأس بعد مِنْ البشر، وأؤمن كذلك بأنَّ كُلّ شيء إنَّما يبدأ بالطُّفولة، وأيضًا فأنا مِنْ الَّذين عاشُوا طُفولة جميلة هادئة وادعة مُثمرة فلا أرضى أنْ يعيش أيّ طفل في بيئةٍ صاخبةٍ مُمزَّقةٍ مُتناحرةٍ.. أنا ضعيف جدًّا جدًّا أمام الأطفال.. هم أنقى الكائنات وأجملها لأنَّهم على سجيَّتهم وفطرتهم وتلقائياتهم الَّتي لم تتلوَّث بعد.. الحُبُّ سيِّدتي والمسؤُوليَّة أيضًا.. ولكنَّ الحُبّ أوَّلًا..
وما سرُّ تولُّد هذه المسؤُوليَّة لأجل الطفل والكتابة له؟
أنا لا أحتمل أنْ يعيش أيّ طفل في العالم بعيدًا عن حنان ورعاية أبويَّه، مِنْ حقِّه أنْ يعيش وادعًا فلا دخل له باختيار سيِّئ.. إنجاب الأطفال مسؤُوليَّة جسيمة. ناقشت في بعض مُؤلَّفاتي ضرُورة تلاشي المُشكلات الأُسريَّة قبل أنْ تتفاقم فيكُون الحلّ النِّهائي بالطَّلاق، الذي هُو كما نعرف أبغض الحلال عند الله عزَّ وجلَّ.. حتَّى وإنْ حدث الطَّلاق فهُناك رعاية لابُدّ أن تقدَّم للطِّفل مِنْ كلا الأبوين.. أنا لا أحتمل أنْ أرى طفلًا يئنُّ تحت نير الفقر والعوز فلابُدّ أنْ يُوفَّر لهؤُلاء الأطفال المأكل والمشرب والمأوي.. بالإضافة إلى حقَّهم في التَّعليم المُناسب.. فما ذنبُهُم الَّذي جنوه.. أنا أحمل المسؤُوليَّة كاملة للآباء والأُمَّهات والمُجتمع بكُلِّ فئاته ومُؤسَّساته، وأنبئُهم بأنَّ الله لن يتسامح مع أي إنسان كان سببًا في حرمان الطِّفل من ابتسامته البريئة..
أهديتَ كتاب «أشهر المُبدعات في تاريخ الأدب العالمي» إلى أوَّل مُحفِّزٍ لك على النَّجاح في أوقاتك الصَّعبة، وأوَّل مَنْ رأيتُه مُمْسكًا كتابًا يقرؤُه بنَهمٍ، وأيضًا هو أوَّل إنسان رأيتُه يرتدي زيًّا عسكريًّا، وأوَّل مَنْ عبَرَ قناة السُّويس في حرب أكتُوبر.. الخال «عفَّت حشمت». ما أثر الخال على «وفيق صفوت مختار»؟
هُو الخال الذي كان نهمًا بشكلٍ غير عادي في القراءة، عندما غرس الله سُبحانه وتعالى حُبّ القراءة في أعماقي ظهر في حياتي هذا الخال الجميل ليدعم حُبِّي للقراءة.. فجعلته مثلي الأعلى.. أمَّا على المستوى الإنساني فقد كان أحد الدَّاعمين لي على طُول الخطّ.. احتفظت بعلاقةٍ رائعةٍ معه وكان لقائي الأسبوعي به بمثابة ارتياح نفسي لي رغم آلامه.. وكانت صدمتي كبيرة بهجرته إلى الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة فقد فقدت ونسًا ودفئًا..
تناولت طفلنا العربي اليوم في عصر الرقمنة والإبهار التواصلي في عدة كتابات ومُؤلَّفات وفيرة ومفيدة. ما أثر بعثرة الطفولة بين عدة أصعدة من الاهتمامات والاتجاهات، كالأسرة، الترفيه، الدِّين، الفن.. وغير ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي؟
تناولت قضية إدمان الإنترنت واعتبرت أنها حالة نظريَّة من الاستخدام المرضي لشبكة الإنترنت، تصْعُب مُقاومتُها، وتؤدِّي بالضَّرُورة إلي التَّعوُّد الذي قد يتحوَّل إلى نمطٍ سُلُوكيٍ يُلبِّي – بشكلٍ وهميٍّ أو حقيقيٍّ – حاجات أو رغبات نفسيَّة وحياتيَّة، والذي قد يَنْتج عنه اضطرابات مُتعدِّدة ومتنوِّعة في السُّلوك، كما تناولت طرق اكتشافه، وأهم دوافعه، وأثاره الضَّارة، وعرضت كذلك لطرق الوقاية والعلاج. ولعل أثاره السيِّئة تتمحور في تفشي مشاعر العزلة الاجتماعيَّة والاكتئاب بين الأطفال والمُراهقين، وانخفاض الطاقة الإبداعيَّة والإنتاجيَّة، كما يُسبِّب إدمان الإنترنت: الأرق، واضطرابات النوم، وخلل دورة النوم الطبيعيَّة، لأنَّ السَّائد هو الاتصال والدُّخول إلى الشَّبكة ليلاً، وهذا يؤدِّي إلى النوم فترات قليلة قد لا تتجاوز السَّاعتين ممَّا يُسبِّب الإرهاق الجسدي والنفسي. كذلك ضعف الجهاز المناعي والوظيفي ممَّا يجعل الشَّخص عُرضة للإصابة بالكثير من الأمراض، فالجلوس الطويل يُسبِّب آلام الظهر، والعمود الفقري، والتهاب العينين نتيجة التعرُّض للإشعاعات الكثيرة ممَّا يُسبِّب ضعف النظر. كما أنَّ الجلوس الطويل لسَّاعاتٍ عدةٍ يؤدِّي إلى ركودٍ بالدَّورة الدَّمويَّة، ممَّا يُسبِّب حُدُوث جلطاتٍ دماغيَّةٍ وقلبيَّةٍ، وضعفاً في أداء الأجهزة الحيويَّة بالجسم. ولعلّ الأخطار الأخلاقيَّة لشبكة الإنترنت على الأطفال و الشَّباب تتزايد يومًا بعد يوم، فقد فتحت لهم أبواب الإباحيَّة بكُلِّ صورها، وبلا حُدُود أو ضوابط. ولقد ذكرت وزارة العدل الأمريكيَّة في دراسةٍ لها أنَّ تجارة المواد الإباحيَّة تجارة رائجة جدًّا، يبلغ رأس مالها نحو مليار دُولار، ولها أواصر وثيقة تربطها بالجريمة المنظَّمة.
برأيك هل الوعظ الفكري المُستمر يقُود إلى المزالق حينًا؟
أنا لا أميل على الإطلاق إلى أيّ نوع من أنواع الوعظ والإرشاد المُباشر الَّذي يأمُر ويُنهي، أنا أُؤمن بتقديم المثل الأعلى والقُدْوة فمن المُستحيل أنْ أقول للطِّفل لا تكذب ثُمَّ نكذب أمامُه بقصدٍ أو بغير قصدٍ، علينا أنْ نُطبِّق على أنفُسنا ما نُريد أنْ نُطبقه على أطفالنا.. نحن نعيب على كُتَّاب قصص الأطفال، على سبيل المثال مُباشرتهم فيما يكتُبُونه وأنْ تتحوَّل القصَّة إلى درسٍ مدرسيٍّ جافٍ يحمل الكثير مِنْ الأوامر والنَّواهي.. في المُراهقة أيضًا وفي كتابي: «سيكُولُوجيَّة المُراهقة»، أكَّدت أنَّ المُراهق لا يُحبّ أبدًا المواعظ والإرشادات، إنَّما يُحبّ أنْ نُناقشه وأنْ يتَّسع صدرُنا لفهم مُشكلاته واستيعاب قيمه ومُعتقداته.. أمَّا إصرار بعض الآباء أو الأُمَّهات على تقديم مبادئ النُّصح والإرشاد دُون احتواء لأبنائهم فسينتج عنه بلا شكّ صدَّام بين الآباء والأبناء نحن في غنى عنه، ونوع مِنْ العناد يُؤدِّي إلى المهالك..
تحدَّثتَ عن التَّربية الجنسيَّة للأطفال والمُراهقين في مُؤلَّفين على ما أعتقد، كما أيَّدت تقديم التَّربية الجنسيَّة في المنزل والمدرسة والجامعة ودور العبادة ومُؤسَّسات تنظيم الأسرة في كتاب «سيكُولُوجيَّة النُّمُو والارتقاء في المُراهقة». بالمُقابل هناك مَنْ يرفُض هذه التَّربية على العلن بمعنى خارج المنزل، بل ويرى في ذلك فُجُورًا وخُرُوجًا عن الأعراف ولفتًا لأنظار الأطفال وعُقُولهم وقُلُوبهم. ما ردك عليه، وما وجهة نظركم الإسلاميَّة والإعلاميَّة في تقديم هذه التَّربية كنوعٍ من الرَّسائل الإعلاميَّة المُوجَّهة للأطفال؟
التَّربية الجنسيَّة Sex Education هي ذلك النوع من التَّربية التي تمد الفرد بالمعلومات العلميَّة، والخبرات الصالحة، والاتجاهات السليمة إزاء المشكلات الجنسيَّة، بقدر ما يسمح به نموّ الطفل أو المراهق جسميًّا وفسيولوجيًّا وعقليَّا وانفعاليًّا واجتماعيًّا، وفي إطار التَّعاليم الدِّينيَّة، والمعايير الاجتماعيَّة، والقيم الأخلاقيَّة السَّائدة في المجتمع، ممَّا يؤهل الطفل أو المُراهق لحسن التَّوافق في المواقف الجنسيَّة، ومواجهة مشكلاته الجنسيَّة في الحاضر والمستقبل مواجهةً واقعيةً تؤدي إلى الصِّحَّة النفسيَّة.
أمَّا مَنْ يقوم بالتَّربية الجنسيَّة، فهناك دراسات تدور حول ما إذا كان من الأفضل أن تترك مسؤولية التَّربية الجنسيَّة على عاتق المدرسة، أو تترك كلية على عاتق الوالدين. وواقع الأمر فإنَّ التَّربية الجنسيَّة يجب أن يتعاون فيها كُلّ من:
• الوالدان: إذا توافرت النية، وصدق العزم، واتسع الوقت، وتوفرت المعلومات العلميَّة، ووجهت إليه عناية خاصَّة بقصد إعدادهم للقيام بدورهم في التَّربية الجنسيَّة.
• المُربون: أو الرُوَّاد، أو الأخصائيون الاجتماعيون بالمدرسة.
• علماء النَّفس: خاصَّة المرشدون، والمُعالجون النَّفسيون، و هؤلاء عليهم رسالة مزدوجة وقائيَّة وعلاجيَّة، مع الأطفال والمُراهقين والأزواج. وعلى المُرشد النَّفسي بصفةٍ خاصَّةٍ أن يقوم بدور فاعل في التَّربية الجنسيَّة.
• الأطباء: في عملهم العلاجي، وقيامهم بإلقاء بعض المحاضرات.
• رجال الدِّين: في الوعظ والإرشاد الدِّيني.
وفي المدارس بالذَّات يمكن دعوة بعض المختصين من علماء النَّفس، والأطباء، ورجال الدين.. وغيرهم لإلقاء محاضرات، وحضور ندوات، ومناقشات، حيث يتناول كُلّ منهم الموضوع من زاويته وتخصُّصه، ويحسن في هذه الحالات أن تُقدَّم الاستشارات والأسئلة مكتوبة، وهذا يُقلِّل من الحرج والخجل الذي يشعر به البعض.
ولكن متى تبدأ التَّربية الجنسيَّة ؟ يجب أن تكون التَّربية الجنسيَّة عملية مستمرة، ولا تقتصر على سن مُعيَّنة، بل تبدأ من الطفولة ثُمَّ تستمر خلالها مرورًا بمرحلة المُراهقة حتَّى الرشد، كما تستمر قبل الزواج، وأثناءه، وبعده.
كتبتَ: «طفلك في خطر مع قصص الخيال العلمي». ما السبب ؟ علمًا أنَّ هُناك مَنْ يرى أنَّها تحفز خيال الطِّفل وإبداعه؟
أنا بالطبع مِنْ أشدِّ المؤيدين لقصص الخيال العلمي التي يمكن التي تُقدَّم لأطفالنا، ولكنَّي أقصد أنَّ هُناك بعض المثالب لقصص الخيال العلمي، ينبغي أنْ نلتفت إليها حتى يُمكن تلافيها، فبعض التَّفسيرات الخياليَّة للحقائق العلميَّة قد تضُرُّ بالطِّفل أكثر ممَّا تنفعُه؛ لأنَّها تقدُّم له هذه الحقائق مُشوَّهة خُرافيَّة وباطلة، فتجعلُه يعيش في دوامةٍ من الأوهام بدلًا من العمل على تقريب المفاهيم العلميَّة وتبسيطها له، والانطلاق به إلى مجالاتٍ أوسع وأفاق أرحب يعمل فيها العقل، فيتُوق إلى إمكاناتٍ أكبر غير التي توصَّل إليها العلم في عصرنا الحاضر، كإمكان أنْ يعيش الإنسان في قيعان البحار أو المُحيطات، أوفي مجاهل الفضاء.
كما أنَّ القصص الخياليَّة وخاصَّة الأجنبيَّة المُستوردة قد يشُوبها بعض المآخذ التي تُلحق الضَّرر بأطفالنا العرب، ذلك أنَّها تعمل على استلابهم وتُلغي قيمة الإنسان العادي، وتجُرَّهُم إلى الحلول الهُرُوبيَّة والانهزاميَّة، وتدفعهُم إلى مُحاكاة أبطالٍ لا وُجُود لهُم في الواقع، إضافة إلى مظاهر العُنف والأعمال الخارقة للطَّبيعة البشريَّة، وإلى إمكان اندماجهم السَّريع مع أبطال هذه القصص وتقمُّص أدوارهم وتأثُّرهم بهُم، وهٌو تقمُّص سلبي بلا شك.
وقد يكُون التَّقمُّص مُجديًا في عديدٍ من الحالات، وذلك حينما يكتسب الطِّفل أنماط السُّلوك السَّوي، والكثير من العادات والتَّقاليد والقيم المرغُوب فيها، لذا وجب اختيار أبطال القصص التي نُقدِّمها لأطفالنا العرب ممَّن تتوافر فيهم الخصائص الأخلاقيَّة والسُّلوكيَّة التي تتماشى مع أهداف التَّربية السَّويَّة، والتي تُؤكِّد الجوانب الإيجابيَّة والمثاليَّة في نُفُوس أطفالنا.
ولقد نبهت مُنظَّمة اليُونسكو UNESCO في تقريرها المُعنون: (جُمهُور الأطفال: تقريرٌ عن صُحُف الأطفال وأفلامهم وإذاعاتهم) الذي كتبه البُرُوفسُور الفرنسي «فيليب بُوشار» وترجمه إلى اللُّغة العربيَّة «مُحمَّد أنور الحنَّاوي» إلى خُطُورة الرَّجل الخارق للطَّبيعة في قصص الغزو الثَّقافي الأجنبي، وحذَّر البُرُوفسُور من أُسطُورة هذا البطل (السُّوبرمان)، ودعا إلى مواجهتها فكريًّا وفنِّيًّا وإبداعيًّا، كما أوصى بضرُورة اختفاء هذه النَّماذج الخارقة (شخصيَّات الإنسان الآلي) لتحُلّ محلَّها مخلوقات إنسانيَّة معقُولة قريبة إلى الواقع.
«وفيق صفوت مختار »عندما يختار المرأة كسيرةٍ ذاتيَّةٍ لقلمه السَّيَّال.. نجدُه يعنُونها برُمُوز مِنْ: السَّيطرة، التَّمرُّد والتَّفرُّد بدءًا مِنْ «جاذبية سري» إلى «أرتيميزيا» و«جُورج إليُوت». مَنْ هي المرأة المُتمرِّدة المُتفرِّدة وفق تصوُّرك؟
نعم أنا مِنْ أشدِّ المُؤيِّدين للتَّمرُّد الإيجابي، وليس التَّمرُّد السَّلبيّ الذي لا يُؤدِّي إلى أيِّ شيءٍ، التَّمرُّد الإيجابيّ الَّذي أقصدُه وأعنيه هو الَّذي يقُود للثَّورة تجاه القيم والعادات البالية، أو الخرافات والخُزعبلات الَّتي يُمكن أن يعش فيها المُجتمع، الثَّورة ضدّ المُمارسات العُنصريَّة المُرتبطة بالجنس أو اللَّون أو الدِّين.. هذا هُو التَّمرُّد الَّذي أُشجِّعه وأدعُو إليه. في كتاباتي كما تذكرين كتبت عن تمرُّد الفنَّانة المصريَّة «جاذبيَّة سرِّي» التي كشفت في لوحاتها الأوَّلى عن ثوريَّتها، والَّتي تعكس حالة الغليان والغضب في الشَّارع المصري، وتُندِّد بوُجُود مُحتل يغتصب حقّ الشُّعوب في الحُرِّيَّة والاستقلال. كذلك الأديبة الأمريكيَّة «بيرل بك « الَّتي دافعت عن الملوَّنين بشجاعةٍ وبسالةٍ، وهاجمت كُلّ انتهاكات حُقُوق الإنسان، وتألمت لكافَّة مُمارسات التَّفرقة العُنصُريَّة، وكتبت عن المطحُونين في كافَّة أرجاء الأرض. أيضًا الأديبة «نادين جُورديمير » الَّتي نشرت مئات المقالات تُندِّد فيها بالتَّفرقة العُنصريَّة، وقدَّمت في رواياتها وقصصها القصيرة صُورًا نابضةً للحياة المُهينة الَّتي يعيشُها الزُنُوج، الأمر الذي عرضها للكثير مِنْ التَّعنُّت، فقد تعرَّضت مؤلَّفاتها للتَّفتيش، وصادر النظام العُنصُري ثلاثة مِنْ أهمِّ كتبها: «عالم الغُرباء»، و «العالم البُرجُوازي الأخير»، و «ابنة برجر». كما وُضعت تحت الإقامة الجبريَّة لمُددٍ طويلةٍ، وعلى الرغم مِنْ ذلك تسلَّلت كتبها إلى النَّاس، وعبرت الحُدُود، وتُرجمت إلى العديد مِنْ اللُّغات، وفازت بجائزة نوبل في الآداب.. وغيرهن.
لم وصفَّت الشَّاعر الكبير «أمل دُنقُل» بـــــــ «شاعر اليقين القومي» ؟
في حقيقة الأمر فأنا استعرتُ هذا الوصف مِنْ الشَّاعر الكبير «فارُوق شُوشة»، وهُو وصفٌ مُلْهمٌ ينطبق على تجربته الشِّعريَّة انطباقًا يكاد يكون تاًّما. لقد كان «أمل دُنقُل» شاعرا ثائرا، صادقا، مُلتزما بقضايا الإنسان والوطن، توَّاقا للعدالة والحُرِّيَّة. ما زلتُ أذكُر له قصيدة «البُكاء بين يدي زرقاء اليمامة»، ليكشف عن الخلل الخطير الذي أدَّى إلى وقوع كارثة الهزيمة في عام (1967م). لم تكُن القصيدة تعبيرًا عن البُكاء، بل كانت مُحاولة جادَّة وجريئة لتصوير ما حدث على أرض الواقع، وشرح أسبابه الحقيقيَّة. في سبيل هذه الغاية، استعان الشَّاعر بشخصيِّتين من التُّراث العربي هُما: « زرقاء اليمامة »، و« عنترة العبسي »، للتَّعبير عن بُعدين مِنْ أبعاد هذه المأساة القوميَّة.
حاورتَ الكاتب والروائي المصري «خيري شلبي». بماذا خرجت ككاتب وإنسان من هذا الحوار؟
«خيري شلبي» هو رائد ومؤسِّس الفانتازيا التاريخيَّة في الروايَّة العربيَّة المعاصرة. وهو أحد أهم أدباء جيل الستينيَّات مِنْ القرن المنصرم. كان مِنْ أوائل مَنْ كتبوا بما يُسمَّى الآن «الواقعيَّة السحريَّة»، ففي أدبه الرِّوائي تتشخَّص المادة وتتحول إلى كائنات حيَّة تعيش، تؤثِّر وتتأثَّر، حيث تتحدَّث الطيور والأشجار والحيوانات والحشرات وكُلّ ما يدب على الأرض، فيصل الواقع إلى مستوى الأسطورة في سلاسةٍ لا مثيل لها، وتنزل الأسطورة إلى مستوى الواقع بنفس السلاسة والتدفق، ولكن القارئ يُصدق ما يقرأ ويتفاعَّل معه. قدَّم أصناف السَّرد كافة من قصةٍ قصيرةٍ، وروايةٍ طويلةٍ، كما كتب الرِّوايَّة القصيرة، والمُسلسل التليفزيوني، بالإضافة إلى عمله في الصحافة، هذا بخلاف نشاطه الإداري والثَّقافي في المطبوعات الثَّقافيَّة المتنوعة، التي قفزت قفزة نوعية هائلة في عهده.
لقد ظلَّ يحكي عن الفقراء والمُهَمَّشين، وواقع الريف المصري دون كلَّل أو ملَّل، عاش ورحل ليُحقق رسالته التنويريَّة، دون أن يشغل باله بما يُكتب عنه، أو ما يناله من جوائز.. إنَّه «حكواتي» مصر الأوَّل.
حاورته في منزله بضاحية «المعادي» بالقاهرة في عام (1999م)، كان الرَّجل ودودًا للغاية، ومتواضعًا لأقصى حدٍّ، بدأت الحوار، واستفاض الكاتب الكبير في الحديث لأكثر مِنْ ساعتين، دون أن يبدي أي علامة من علامات الضيق أو التبرُّم.. ولما انتهي الحوار قال لي بالحرف الواحد في موقف لن أنساه أبدًا ما حييت: «أنت شرفتني واستنزفتني».
بعد هذه الرِّحلة الثَّريَّة.. أودُّ أنْ أرسُو على شطِّ «البُورتريه الصِّحافي» الَّذي أبدعت وأذهلتنا به. برأيك ورغم وُجُود شخصيَّات مُؤثَّرة ومُتجدِّدة على السَّاحات السياسيَّة والاجتماعيَّة والفنيَّة والثَّقافيَّة.. ما سبب تراجُع هذا الجنس الصِّحافي إلى حدِّ الغياب والفقد رُبَّما؟
هُناك مَنْ يكتبُون البُورتريه الصِّحافي ولكنَّهم قلائل، كما أنَّ غياب الدَّور الفاعل للصُّحُف والمجلَّات الورقيَّة التَّقليديَّة قد قلَّص نصيب البُورتريه مِنْ الذُّيوع والانتشار. كُنت أُتابع جميع البُورتريهات الَّتي كان ينحتها أستاذُنا «خيري شلبي» ولقد كانت له مدرسة خاصَّة به، تميَّز بها ولم يستطع أحد تقليدها، وعندما كتبت أوَّل بُورتريه عن الأديب البُرتُغالي «جُوزيه سارماجُو».. حياةٌ بطعم العُشب البرِّي، لمجلَّة «دُبي الثَّقافيَّة»، الَّتي كانت تصدُر مِنْ دولة الإمارات العــــربيَّة، تمَّ نشرُهُ في العدد:90 ، نوفمبر (2012م). بعدُها تلقَّفتني المجلَّة واتَّفقت معي – ضمنيًّا – على تقديم مثل هذه البُورتريهات، وبالفعل فقد كتبت للمجلَّة (28) بُورتريهًا. وهُو ما جعلني أهتمّ حتَّى بعد توقُّف المجلَّة بأنْ أكتب بُورتريهات جديدة ونشرها في مجلَّاتٍ أُخرى كثيرةٍ ورقيَّةٍ أو إلكترُونيَّةٍ.
ووفقًا لخزينتك الوافرة به، أين تكمُن أهمية البُورتريه الصِّحافي، وهل أنت مع فكرة أنْ يُقدِّم الصِّحافي رأيه في ماَّدة البرُوفايل؟
تكمُن أهميَّة البُورتريه الصِّحافي في التَّعريف الدَّقيق والمُكثَّف للشَّخصيَّة الَّتي يكتُب عنها الصِّحافي أو الكاتب، وأنْ يمتاز أُسلُوبُه بعناصر: التَّشويق والجاذبيَّة والسَّلاسة، وكذلك بدقَّة المعلُومات المُقدَّمة، وبالتَّالي تحفيز القارئ على الاطلاع المُوسَّع لصاحب الشَّخصيَّة. أمَّا مِنْ حيث تقديم الصِّحافي لرأيه في مادَّة البرُوفايل، فأنا مع ذلك تمامًا، ولكن مِنْ خلال قراءاتٍ عميقةٍ ومُتعدِّدةٍ مِنْ مصادر موثُوق بها، ثُمَّ يخلُص الصِّحافي إلى أفكارٍ ورُؤى بعينها قد لا يراها غيرُه، فالكاتب إنَّما يتقمَّص شخصيَّة الأديب، أو العَالِم، أو الفنَّان الذي يكتٌب عنه، على أنْ تكون هذه الرُّؤية وفقًا لقاعدةٍ نُسمِّيها: قاعدة «الموضُوعيَّة»، أي الحياديَّة وعدم التَّحيُّز ، وكذلك قاعدة: «المصداقيَّة» فيما يطرحه الصِّحافي مِنْ معلوماتٍ، حتَّى يثق القُرَّاء فيما يكُتُبه.
حاورت الكاتب «يُوسُف ميخائيل أسعد»، قد يلحظ القارئ وُجُود تقاطع فكري ثقافي بين مؤلَّفاتك ومؤلَّفاته. صاحب «سيكُولُوجيَّة الإلهام».. هل كان له دور في توجُّهك وإلهامك للكتابة نحو الطِّفل؟
كان لزوج خالتي المُقيم بضاحية «مصر الجديدة» بالقاهرة مكتبة جميلة تحتوى على مُؤلَّفات «يُوسُف ميخائيل أسعد»، وقد عرفت منه أنَّه مُتزوج مِنْ شقيقته، وقد كانت هذه المفاجئة فتحًا جديدًا في تكويني الإبداعي في مجال التَّربية وعلم النَّفس. تواصلت مع هذا الكاتب الرَّائع عن طريق زوج خالتي، فكُنت أزُوره كُلَّما أتيت إلى القاهرة. بالطَّبع كان يهديني مُعظم مُؤلَّفاته السَّيكُولُوجيَّة والفلسفيَّة الرَّائعة، التي بدأت في التهامها. كانت مُؤلَّفاته رصينة وعميقة. ظلّ الرَّجُل يُشجِّعني حتَّى قدَّمت له كتابي الأوَّل، المُعنون: «مُشكلات الأطفال السُّلوكيَّة»، ليُقيمه، فما كان منه إلَّا أنْ يهديني مُقدِّمة موضُوعيَّة راصدة وكاشفة، وبالفعل صدر الكتاب في عام (1999م)، وهو يحمل مُقدِّمته الرَّائعة. ظلَّت علاقتي به وثيقة حتَّى تُوُفِّي في عام (2001م).
في الختام .. هل نشهد مولُودًا جديدًا على السَّاحة الثَّقافيَّة قريبًا؟
أجدُ الآن مُشكلات جمَّة مع أغلب دُور النَّشر في مصر ، وذلك بسبب الحالة الاقتصاديَّة المُتردِّية والَّتي انعكست على صناعة الكتاب، فقُمت بتأجيل بعض مشرُوعات الكُتُب لحين تحسُّن الأوضاع. ولكنّ هذا لا يمنع مِنْ البدء قريبًا بإذن الله تعالى في كتابة (الجُزء الثَّاني) من «موسُوعة العُلماء العرب.. قديمًا وحديثًا»، والَّتي صدر (الجُزء الأوَّل) منها في عام (2022م). سيحتوي (الجُزء الثَّاني) على عُلماء العرب في مجالات: الكيمياء، والأحياء، والطِّبُّ، والصَّيدلة. المادَّة العلميَّة جاهزة، والخُطَّة مُعدَّة، أحتاج فقط إلى نوعٍ مِنْ التَّشجيع لأبدأ المهمَّة الشَّاقَّة المُمتعة.
وهل يُمكن أنْ نشهد مولُودًا عن أشهر المُبدعات في تاريخ الأدب العربي ؟
آه.. هذه أُمنيتي.. المادَّة العلميَّة مُتوفّرة إلى حدٍّ معقول، ينقُصُني فقط بعض المصادر لتغطية جوانب بعينها، ولكنّ هذا لا يُمثِّل مُشكلة، المُشكلة الحقيقيَّة تكمُن في وجود النَّاشر الَّذي سيتبنَّى هذا العمل الموسُوعي الضَّخم في ظلِّ هذه الظُّروف الصَّعبة، كما أنَّ جُهدي قد بدأ يقلُّ وينقص نتيجة عامل السِّن، وهذا شيء يجب أنْ نحترمه ولا نهرب منه.. سأُحاول.. وليهبني الله سُبحانه القُوَّة والقُدرة.
الكلمة الأخيرة لك أُستاذنا الكريم:
سعادتي لا تُوصف بهذا الحوار الَّذي لم يكُن إعدادُه سهلًا بالمرَّة.. فأشهد أمام الله العظيم أنَّك صحافيَّة مُبدعة ومُتألقة وصبُورة ومُهذبة، لقد بذلتِ جُهدًا شاقًا في جمع المعلُومات الَّتي منحتكِ القُدرة على طرح أسئلةٍ عميقةٍ وثريَّةٍ ومُتفرِّدةٍ.. أتمنَّى أنْ أكُون عند حُسْن الظَّنّ فأنا لست مُتمرِّسًا في تقديم مثل هذه الحوارات، وأرجُو أنْ يكون الحوار بمثابة دافع وحافز على قراءة أعمالي السَّيكُولُوجيَّة والتَّربويَّة، وكذلك أعمالي في مجال التَّراجم والسَّير الذَّاتيَّة.. حفظكِ الله وأسعدكِ.. وكلَّل حياتك الشَّخصيَّة والعمليَّة بالنَّجاح والسَّداد.
قامت بإجراء الحوار وإعداد الأسئلة: هبة عبد القادر الكل
السيرة الذاتية للكاتب وفيق صفوت مختار
* من مواليد 19 يناير 1958م، جمهورية مصر العربيَّة، محافظة سوهاج، مدينة طهطا.
* حاصل على ليسانس الآداب والتربيَّة، جامعة أسيوط، كلية التربيَّة بسوهاج عام (1980م)، ودبلوم خاص في التربيَّة وعلم النفس من ذات الجامعة عام (1984م).
* كبير الأخصائيين التربويين بوزارة التربيَّة والتعليم بدرجة وكيل وزارة، وهو محاضر تربوي في تجمعات الشَّباب، وأعضاء هيئات التدريس، وأولياء الأمور.
* عمل مُحرِّرًا صحافيًّا بمجلة «هو وهي» (قبرص)، ومجلــة «دُبي الثقافيَّة» (دولة الإمارات العربيَّة).
* فاز بجائزة الشيخ «عبد الله المبارك الصباح» للإبداع العلمي على مستوى الوطن العربي، عن نتاجه المتميِّز «المُخدرات وأثرها المُدمِّر»، وقد تلقى خطاب شكر وتقدير من السَّيِّدة «سوزان مبارك»، بمناسبة ظهور بعض مؤلفاته التربويَّة عام (2002م).
* أُدرجت سيرته الذَّاتية والعلمية وأهم مؤلفاته بالموسوعة الحُرَّة “ويكيبيديا”.
* اُستخدمت مؤلَّفاته في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، وكمراجع للعديد من المقالات والدراسات المنشورة على صفحات المجلات والدوريات العربيَّة، كما قام بكتابة مقدمات لعدد من الأعمال الأدبيَّة والفكريَّة الثرية، منها: “بيت بلا نافذة” للأديبة المصريَّة: ريم خيري شلبي عام (2020)، و”مئة كتاب في كتاب”، للكاتب السوري: حواس محمود عام (2021م)، و”مرج الزهور”، رواية الأديبة السورية: فاديا عيسى قراجة عام (2021م).
* سجل للتلفزيون المصري، على قناته السَّابعة، العديد من الحلقات التربويَّة والثقافيَّة في عدة برامج، منها: برنامج: «الطفل والمجتمع»، وبرنامج: «أوراق ملوَّنة ».
* تناولت الصحف والمجلات المصريَّة والعربيَّة مؤلَّفات الكاتب بالنقد والتحليل والعرض والإعلان، كجريدة “المصري اليوم”، جريدة “الأهرام اليومية”، “المجلة العربية” و”مجلة الشارقة الثقافية”.
* للكاتب أكثر من (28) بُورتريهًا صحفيًا منشوراً في “مجلة دبي الثقافية” وغيرها من المجلات الورقية والإلكترونية.
* للكاتب (122) مقالة ودراسة منشورة في عدة مجالات تربويَّة، سيكولوجيَّة، علميَّة، أدبيَّة، ثقافيَّة، وغيرها، على صفحات المجلات والدوريات المصريَّة والعربيَّة.
* للكاتب (65) دراسة تتعلَّق بالسير الذَّاتية (أدب التراجم)، في مختلف المجالات، وفي مقدمتها: الآداب والفنون التشكيليَّة، وقد نُشرت في المجلات والدوريات المصريَّة والعربيَّة.
* له (25) حوارًا أجراها مع كبار الشعراء والأدباء وقادة الفكر في مصر، والتي نُشرت بالمجلات والدوريات المصريَّة والعربيَّة، ومن أمثلة تلك الحوارات المدروسة الغنية: حواره مع الكاتب “يوسف ميخائيل أسعد”، الشاعر “أحمد سويلم”، الأديبة “سكينة فؤاد”، والروائي “خيري شلبي”، وغيرها.
* له ثلاثة كتب في التراجم والسير الذاتية للأطفال، والتي نُشرت على صفحات مجلة قطر الندى المصرية، وهي: “رفاعة الطهطاوي.. رائد التنوير” عام (1996م)، “ماما.. نبوية موسى” عام (1997م)، و”الفنان محمود سعيد.. وطني مُلهمي” عام (1997م).
* صدر للكاتب (72) كتابا منشورا خلال الفترة الواقعة ما بين عام (1999م) إلى عام (2023م)، وقد تناولت تلك الكتب مواضيع شتى في سيكولوجيا الأطفال ومشكلاتهم وصحتهم النفسية، وفي الأدب والرواية والشخصيات التاريخية المؤثرة وفي تنمية الذات، من تلك الكتب: “أشهر 100 شخصيَّة تاريخيَّة أبهرت العالم” عام (2023م)، “الموسوعة العربيَّة الأولى الجامعة الشاملة: موسوعة العُلماء العرب.. قديمًا وحديثًا” عام (2022م)، “مذكرات من منزل الأموات” رواية للكاتب الروسي «فيودور دوستويفسكي» عام (2022م)، “استراتيجيات مواجهة مشكلات الأطفال” عام (2022م)، “أمل دنقل.. شاعر اليقين القومي” عام (2021م)، “محمَّد الماغوط.. شاعر المقاومة والثورة والحُرِّيَّة” عام (2021م)، “من أشهر رائدات الأدب العالمي” عام (2021م)، ” سيكولوجية النمو والارتقاء في المراهقة” عام 2019م، ” لا تدع القلق يُسيطر على حياتك” عام (2019م)، ” تربية الأبناء في عصر الإنترنت” عام (2018م)، “كيف تقوي ذاكرتك وتتغلَّب على النسيان” عام (2018م)، “الاكتئاب مرض العصر: كشف أسراره، ومعرفة أسبابه، واستراتيجيات الوقاية والعلاج” عام (2017م)، ” وسائل الاتصال والإعلام وتشكيل وعي الأطفال والشَّباب” عام (2010م)، ” كتب ومكتبات الأطفال وتنمية الميول القرائيَّة” عام (2009م)، “سيكولوجيَّة الأطفال ضعاف العقول” عام (2005م)، “مشكلة تعاطي المواد النفسيَّة المخدرة” عام (2005م)، “المدرسة والمجتمع والتوافق النفسي للطفل” عام (2003م)، ” أبناؤنا وصحَّتهم النفسيَّة” عام (2001م)، ” مشكلات الأطفال السلوكيَّة” عام (1999م)، وغيرها من الكتب القيّمة التي لا سبيل لحصرها..
#سفيربرس _ إعداد وحوار : هبة عبد القادر الكل